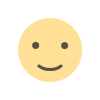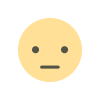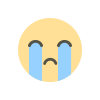لماذا تفشل الثورة و سعينا الدائم نحو التغيير ؟

إن آليات التغيير، إذا كانت حقيقية، عادةً تبدأ بالداخل؛ أما إذا كان التغيير ظاهريًا، أو نابعًا من تأثيرات خارجية، سواء كانت تراكمية أو لحظية، فغالبًا يكون مجرد ظاهرة أو صيحة أيديولوجية يستغلها من يملك السلطة أو النفوذ.
إن التغيير الذي يحدث في المجتمعات المهزومة أغلبه سلبي ظاهري، نابع من تفاعلات داخلية لدى قلة من الأفراد ومحكوم بعوامل الخوف وغرائز البقاء، وحركة 20 فبراير أو نضال أساتذة التعاقد أو حراك الريف بدرجة أكبر خير دليل على ذلك.
وإذا افترضنا أن الرغبة الداخلية للارتقاء أدت إلى انفصال (أقلية ما) على مستوى شكل النضال، ثم تحول هذا الانفصال إلى خروج ومقاومة، وانفجرت إلى فعل ثوري من أجل التغيير أو حتى «حذف» النظام الفاشي المستبد، فهل هذه الرؤية تُعد صحيحة أو كاملة؟ هذا النوع من الرؤى يقلب موازين القوى ويذبذب المجتمع تحت العديد من الشتات (مرة أخرى)، ولكنه لا ينتصر أو يحقق التغيير الحقيقي، بل يغوص أكثر بين طيات الهزائم.
” إذا كان النضال هي حرثٌ لإنبات سنابل الحق والرخاء، فيجب أن ندرك طبيعة الأرض التي سنحرثها، وإلا ذهب الفعل هباء. إننا ننسى دائمًا أننا من النظام، الأنظمة الفاشية منّا ونحن منها، مهما رفضنا هذه الحقيقة. إننا لسنا أبطالًا، وإن من يزرع الأشجار وسط الرمال بعيد كل البعد عن البطولة.“
إن المنظور الفردي، الذي يفتقر بشكل كامل إلى الإدراك الذاتي أو حقيقة الكيان الذي ينتمي إليه (سواء كان هذا الكيان هو النفس أو المجتمع)، سيندمج في وهمين: وهم البطولة، ثم وهم الضحية (بعد الهزيمة الأولى). ونحن قطعًا لسنا ضحايا كما نظن، لذا فاحتمالات الهزيمة غالبة عبر تاريخ البشرية، بسبب تعقيدات مسارات التغيير وندرة حدوثها، وبسبب الكثير من العوامل المؤثرة على عملية الارتقاء (الانتصار)، الخارجية والداخلية.
الهروب
بسبب تركيبة الإنسان وتطور نظام الحفاظ على البقاء لديه غريزا أدى إلى تشكل نوعين من القرار عند مواجهته خطرا ما، القرار الأول يكون عن طريق المواجهة لو تبين للمرء امكانية الانتصار في المواجهة، والقرار الثاني هو الهروب كرد فعل عن الهزيمة. ومن أحد دلائل الهزيمة في المجتمعات المقموعة هي الهروب، والمقصد من هذا الهروب لا يتعلق بهجرة المجتمع أو الفرد، وإنما هو هروب أيديولوجي يتضخم ويتناسب تمامًا مع العوالم الرقمية التي نعيشها الآن.
إن العزلة تجتاح المجتمعات المهزومة، فتنشأ فقاعات اجتماعية مختلفة داخلها، وكل فقاعة تطفو في عالمها الخاص. هذه الفقاعات التي تزيد من تفكك المجتمع وفقدان الهوية. في المغرب مثلًا، نجد بعض العوالم (الفقاعات) الموازية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعرض مشاكل وترفيهيات (ذات ثقافة تختلف عن واقع المجتمع) للطبقات البرجوازية (أو ما يشبهها الآن)، وما يعلوها بالطبع.
وفي عالمٍ آخر، نرى مثلًا بعض ألنضالات الهامشية التي جذبت فئات أكبر من المجتمع في فقاعة أخرى، ويمكن أيضًا إسقاط الأمر على الصراع السياسي بين الأحزاب، وظهور صدام الفقاعات بشكل أكثر وضوحًا في كل فترة انتخابات. لقد رأينا من يدّعون الليبرالية، ورأينا من يدّعون الإسلامية، ورأينا من يقفون بينهما بأشكالٍ مختلفة. الأمر إذن بدأ بشكلٍ تراكمي ويزداد الآن بعنف مع تطور وسائل التواصل وتغير مصادر المعرفة وانتشارها وازدياد الطغيان، ولم يعد الأمر مرهونًا بالطبقية بشكلها التقليدي، فالعوالم كلها مخلوطة.
الطبقية الآن مرتبطة بعوامل أخرى (إلى جانب المال)، كأسلوب الحياة وتبني الأيديولوجيات والأفكار الجذابة للفرد، فيجتمع من يشاركون هذه الأفكار والمفاهيم وسلوكيات الحياة في فقاعتهم الصغيرة؛ ونذكر منها نمودجا: فقاعة التدين والدعوة للحق، ومن الجانب الآخر فقاعة الالحاد، وأيضا النسوية وفي مقابلها ما يسمى بالريد-پيل ... . ورغم كل هذه العزلة والصدامات الهزلية التي حدثت (وما زالت تحدث)، إلا أن كل الفئات تتفق على منظورٍ واحد: النجاة.
وفي الآخير، هذه معضلة حقيقية خاضتها البشرية على مدار العصور. إن الوجود هدفه المقاومة؛ لأن هذا ما يتوافق مع العملية «الحيوية» للأشياء، فالنبات يشق الأرض ويقاوم أوزان التراب لكي ينمو، والحيوانات إمّا تعاني من أجل صيد فرائسها أو تعاني من أجل الخلاص من صائديها. وإن خلايا الجسد تقاوم العجز حتى تهلك كما يقاوم البشر من أجل النجاة، تلك النجاة التي لا ينبغي أن تقتصر على نجاة النبات والحيوان، بل هي سلامة الفكر والنفس من الابتذال.
فالحرية هي مقاومة المسار المضمحل للطغيان، ومحاولات الاستكشاف هي مقاومة «السهل» من العيش في ظلمات الجهل. إن الموت هو الحقيقة الجامعة لكل الأشياء، ولهذا فمحاولات الحياة تكمن في الارتقاء الجمعي والفردي معًا، ولهذا نجد أفرادًا يهزمون أنظمةً بعد موتهم، كسقراط الذي أثّرت تعاليمه في تشكيل علوم الفلسفة وتوضيح رؤيتنا للعالم حتى الآن.
ما هو رد فعلك؟